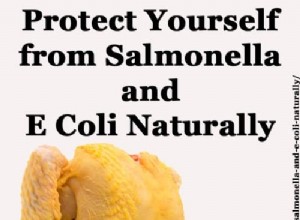ترجمة مصطفى شقيب-المغرب
[email protected]
الضوضاء في كل مكان؛ في العمل، في الشارع، في المنزل : لقد صارت لحظات الصمت نادرة جدا. وهذا يُتعب دماغنا كما تبيّن ذلك علوم الأعصاب، فعندما ينعم دماغنا بلحظات من الخواء الصوتي، يشرع في التجدّد والإحياء.
تقترح علينا عالمة الأعصاب آنا فون هوبفكارتن القيام بتجربة صغيرة ؛ أن نأخذ كتابا ونذهب الى المطبخ ونشغّل آلة شفط الروائح الصاخبة. ثم نشعل أيضا الراديو، في مستوى عال جدّا، بعد ذلك نتخذ مكاننا على كرسي مثير لنبدأ قراءتنا.
ونحن كذلك، تصلنا ضوضاء هي عبارة عن خليط غير منظّم من ترددات صوتية عديدة. في البداية، سيضايقنا الأمر بالتّأكيد أثناء قراءتنا، غير أنّنا سنتعوّد بعد ذلك، فقد نكون ربما من هذه الفئة من الأشخاص الذين يستطيعون التركيز في خضم الضوضاء، وهو الحال بشكل خاصّ لدى الأشخاص المعروفين “بالحساسية الفائقة السمعية”، الذين يقفزون لمجرد طقطقة أو صرير، مفضّلين صوتا خلفيا ثابتا، الذي يخفي كل الأصوات الأخرى غير المرغوب فيها.
بل يتم الآن التسويق في المتاجر عبر الأنترنت ، كما تذكر هذه العالمة ، لمولدات “للأصوات البيضاء” التي تم تصميمها لإغراق السمع بضوضاء ثابتة، والتي تم تصميمها في البداية في إطار معالجة أعراض الطنين الأذني، حيث يلجأ إليه العديد من الأشخاص من أجل استجلاب النوم، والتركيز في العمل أو مجرد الاسترخاء.
لكن هل نؤدي خدمة لدماغنا ونحن نقصفه باستمرار بكلّ أنواع الضوضاء؟ لنعرف ذلك، علينا معرفة ما يتحمّله عموما دماغنا أثناء اليوم : الموسيقى المتواصلة في المحلات التجارية، هدير الآلات الكهربائية، ضوضاء السيارات في الشارع… لقد صار ذلك موجودا في كل مكان إلى الدرجة التي لم يعد بالإمكان ملاحظته، اللهم حينما نجد انفسنا في مكان هدوء مطلق: مشهد طبيعي شتوي بالثلوج، أو على شاطئ بحيرة ضبابيّة أو استرخاء على الأريكة والأصوات منقطعة تماما. حينئذ ندرك إلى أي مدى “الصمت نعمة كبرى”.
وأبدت الدراسات، منذ سنوات عديدة، أنّ الضوضاء تنتهي بنا أحيانا إلى المرض. فقد تم الربط بين الأزيز في ضواحي المطارات أو الطرق السيارة وبين شيوع متزايد للأمراض القلبية الوعائية (خارج عامل التلوث). وللعلم، فمنذ العام 1972، تبنّت الولايات المتّحدة الأمريكيّة قانونا حول الحماية ضدّ الضوضاء، الذي وفقا له، “يتمتع جميع الأمريكيين بحق العيش دون ضوضاء مضرّة”. وفي أوروبا، يؤطر القانون بشكل صارم التعرض للضوضاء، فقد صوتت فرنسا منذ 1992 على قانون يفرض قيودا صارمة على مشيّدي المشاريع الطرقية، او المرتبطة بالسكّة الحديديّة أو المطارات قصد تقنين تعرض السكان لهذه الاضرار، والذي تم تأييده بتوجيهات اوروبية في 2002 ينحو نفس المنحى. ونفس الأمر في ألمانيا، هناك تشريع للحماية ضدّ الضوضاء بواسطة قوانين مختلفة، منها القانون الفيدرالي حول مكافحة التأثيرات الصوتية المضرّة.
فيما استطعنا اليوم، بفضل الابحاث المتقدمة، فهم سبب تجاوب دماغنا التلقائي والفوري مع الأصوات، مهما كانت، بما في ذلك عند نومنا. لقد علمنا انّ الاصوات المجهولة تنشّط مركزا دماغيّاً يدعى “اللوزة” – منطقة مركزية متواجدة في قعر الفص الصدغي تشرع في النشاط في حال الخوف والعواطف السلبيّة الأخرى. إذ يتم إطلاق شلالات من الهرمونات، خاصة على المحور الهيبوتالاموسي-النخامي-فوق الكظري، المعروف بوقوفه وراء تجاوب الجسم مع الاحهاد. وفجأة، يتم إغراق الدورة الدموية بالكورتيزول، هرمون الإجهاد. وهو بمثابة تنبيه إلى الجسم : “حذار، هناك خطر محتمل ! ”
منافع للضغط الشرياني
إنّ الإجهاد على المدى القصير جيّد، يحسّن أدائنا ويجعلنا أكثر استعدادا للطوارئ. كلّ هذا لأن الضغط الدموي يزداد، وتتسارع ضربات القلب وتنقبض عضلاتنا، لكن على المدى الطويل، ينتهي المطاف بالجسم إلى الإتلاف…إلى الحد الذي أعلنت فيه المنظمة العالمية للصحة في تقريرها للعام 2001، أن التلوث الصوتي المتزايد هو “آفة حديثة”.
وإن كانت مولّدات الأصوات البيضاء لا تدخل ضمن هذه التنبيهات الصوتية التي تضع اللوزة الدماغية في حالة إنذار. غير أنّها، مع ذلك، برتابتها تحرم دماغنا مما يحتاجه : لحظات الصمت. وهي لحظات صارت نادرة تم افتقادها في خضم تسارع الحياة الرهيب هذا. وتتساءل الباحثة فون هوبفكارتن : كم عدد المرات في اليوم التي لا نسمع فيها أي شيء؟ غير أنه يمكننا الاستفادة استفادة كبرى من ذلك. وهذا ما اكتشفه الباحثون في علم الأعصاب- مصادفة تقول هذه العالمة- من جامعة بافيا بإيطاليا. فقد أراد لوتشيانو برناردي وفريقه معرفة أي أنواع الموسيقى هي أكثر إفادة للجهاز القلبيّ الوعائيّ. فقاموا في تجاربهم بإسماع متطوعين قطعات موسيقية ذات أنماط مختلفة، من بيتهوفن إلى التكنو ونمط الريد هوت تشيلي بيبرز. وكانوا في نفس الوقت يقيسون التنفّس، والضغط الدموي ومعدل نبضات القلب للمشاركين. وبغرض المقارنة، كانوا يدخلون في قطعاتهم فترات من الصمت، ويتم أخذ نفس القياسات خلالها ايضا. فلاحظوا ما يلي: “عندما يتوقّف الصوت، تشرع الوصلات العصبية التي كانت “بكماء” في “الكلام”. كما لو أنّ الصمت أيقظها !”
والنتيجة: جميع القطع الموسيقية-وخصوصا ذات الايقاع السريع- أدت إلى زيادة في المؤشرات القياسية الثلاثة، مقارنة مع القيم الأولى المسجّلة قبل بداية التجربة. غير أنّ الذي أدهش الباحثين أكثر، هو ما كان يقع أثناء فترات الصمت: فقد كانت قيم المؤشرات القياسية تهبط إلى مستوى أدنى من القيم الأولى المسجّلة.
كان الأمر كما لو أن الصمت قد اكتسب قيمة إضافيّة بعد التعرض للأصوات. وهذا يمكن فهمه : فالمشاركون كانوا يستمعون بنشاط إلى القطع الموسيقية، وبالتالي، كان انتباههم في حالة تعبئة خلال هذه المرحلة. فخلال فترات الصمت، كانوا يتمتعون بلحظة استراحة حيث كان يمكنهم تسريح انتباههم من هذا الاستماع، مصحوب بمفعول استرخاء. وهذا ما يفسّر أننا نستفيد ربّما أقلّ في الصمت الدائم من فترات الصمت المتناوبة مع الفترات الصوتية.
ولتجرّبوا ذلك: اطفئوا جهاز الراديو فجأة، ألا تحسون هذا الصمت الرائع؟ ألا يبدو فجأة عميقا أكثر مما كان قبل تشغيل الأجهزة؟
الوصلات العصبية للصمت
يعود سبب غرابة الإدراك هذا، إلى كيفية عمل خلايانا العصبية. فهذه الأخيرة تحب في الحقيقة التنوع؛ إنها تنشط على الخصوص عندما يتغيّر شيء ما في بيئتها ؛ عند لبس سوار ذهبي جديد مثلا، لم يكن معتادا من قبل، تشرع خلايا القشرة الدماغية التي تعالج أحاسيس اللمس في إعلامنا بعملية لمس. غير أنّه في لحظة معينة، لا تعود الفتاة تشعر بالسوار حول معصمها، ويتحدث علماء الأعصاب هنا عن “عمليّة تعوّد”. وحين تبدّل الفتاة سوارها من جديد، تعود هذه الخلايا للبروز ثانية : لقد تغيّر شيء ما هنا !
ونجد نفس مفعول التباين هذا بوضوح مشتغلا في مجال السمع. فعندما يسمع الشخص صوتا جديدا-مثلا صوت بداية آلة شفط الروائح في المطبخ- يتم تفعيل شبكة من الخلايا العصبية في القشرة الدماغية السمعية، وإذا بقي المنبه السمعي ثابتا لمدة معينة من الوقت، تخفت هذه الخلايا شيئا فشيئا لتصمت نهائيا، لأنه ليس هناك جديد يُذكر.
لكن ماذا يحدث عندما يتوقّف الصوت ؟ هذا ما حاول اختباره عالم الاعصاب مايكل وير وفريقه من جامعة أوريغون بأوجين على فئران المختبر. فقد قام العلماء بإسماع اصوات إلى حيواناتهم، ثم قاسوا نشاط الخلايا العصبية لكل فرد في القشرة الدماغية السمعية. فاكتشفوا أنّه عندما يتوقّف الصوت ليحل محله الصمت، يتم تفعيل وصلات عصبية مختلفة عن تلك التي تم تنشيطها من طرف هذا الصوت. والظاهر، تقول فون هوبكارتن، أنّ الدماغ يحتضن شبكة عصبية مختصّة في الصمت في اللحظة التي يُطلق فيها هذا الأخير، وهذا يتم ترجمته إلى الانطباع المثير أحيانا الذي نشعر به عندما يتم فجأة قطع صوت مستمرّ.
ثلاثة أيام دون ضوضاء !
صار البحث اليوم عن هذا المورد النفيس-لحظات الخواء الصوتي-مبتغى لعدد متزايد من الأشخاص، المستعدين لدفع الأموال من أجله، سواء تعلق الأمر بمخيمات التأمل في الغابة، او الانعزال الصمتي في المعابد، أو السمّاعات المضادة للضجيج، أو ممرات الامتياز في المناطق الصامتة للمطارات.
يبقى الصمت مواتيا لشرود الافكار. عندما نترك العنان لحالة السكون، تتطور مناطق دماغيّة تساعدنا على ضبط أعمالنا الخاصة.
فإن قضيت نهاية أسبوع كاملة دون دردشة، ودون رنات الهاتف ودون هدير المحركات، ستكون شبكتك المرتبطة بالصمت في راحة تامة، لأنها تتجاوب حصريّا مع حدوث الصمت. إذن ماذا يقع في الدماغ عندما نرتاح من صخب الحياة اليومية لفترة طويلة ؟
عناصر الاجابة نجدها عند الفريق البحثي لغيرد كيمبرمان، من المركز الألماني للأمراض التنكسية لدريسد، من خلال إجراء تجارب عن الفئران. ولم يكن الصمت هو المستهدف في حد ذاته من هذه الدراسة، بل شملت أصواتا مختلفة التي أراد الباحثون اختبار قدرتها المنبهة على الدماغ. ففقد تمت دراسة الصمت هنا كعنصر مقارنة تأثير الأصوات وانعدامها.
وهكذا تم تعريض مجموعة أولى لصوت أبيض ثابت ، وأخرى لموسيقى موزارت، وثالثة لصرير صغار الفئران، ومجموعة رابعة تم وضعها في صمت تام. ثم بعد ذلك، وفي لحظات مختلفة، تم قياس عدد الخلايا العصبية الجديدة التي ظهرات في منطقة هامة للذاكرة والتحديد الفضائي: الهيبوكامب أو الحُصَين.
وتنمو الخلايا العصبيّة
مقارنة بالبيئة المعتادة الصوتية للمختبر، كلّ الشروط التجريبيّة – ماعدا الصوت الأبيض – تمت ترجمتها إلى زيادة في الخلايا الجديدة تُعرف ب “الخلايا العصبيّة السلائف” في الهيبوكامب بعد يوم واحد فقط. لكن بالمقابل، كان الوضع مختلفا خلال سبعة أيام: وحدها الفئران التي تم إغراقها في الصمت التام لمدة ساعتين في اليوم توفرت على خلايا عصبيّة جديدة أكثر من الفئران الأخرى، ما يوحي أنّ السلائف العصبيّة التي تم انتاجها في الهيبوكامب لا تتحول إلى خلايا عصبية إلا إذا تم تعريض الحيوانات بانتظام لصمت مطول.
ولا أحد يعرف اليوم إن كانت هذه الملاحظة تنطبق أيضا على الدماغ البشري أم لا.
المزيد من الأفكار خلال الصمت !
ما يعتبره كثير من الناس مضيعة للوقت أو نقص تركيز(يسمع الأطفال الكثير من الكلمات : “ركّز! “) هو في الحقيقة كفاءة مهمّة للدماغ. فترك العنان لأفكاره من وقت لآخر يعزز العبقرية. فالأشخاص الذين يستغرقون بالأحلام بصفة منتظمة قد يكونون أيضا أكثر مرونة على المستوى الإدراكي وقادرين على حلّ المشاكل بسهولة أكبر.
ويميّز النفسانيون بين صنفين من أحلام اليقظة : ففضلا عن الاستطراد اللاإرادي والعفوي للأفكار، هناك شكل آخر نقرّر فيه ترك خاطرنا يسرح في التفكير بوعي منا. فقد اكتشف علماء من معهد مإكس-بلانك للعلوم الإدراكيّة والدماغيّة البشرية بلايبسيتش في 2016 أنّ هذا النوع من الزيغ الذهني مرتبط ببعض التغيرات الدماغيّة. “لدى الأشخاص الذين يتركون العنان لأفكارهم، تكون القشرة الدماغية أكثر سمكا في منطقة القشرة الأماميّة”، يفسّر يوهانس غولتشرت، طالب دكتوراه بالمعهد وصاحب الدراسة. ولهذه المنطقة أهميتها بشكل خاص للتحكم في أفعال الشخص…والصمت، من وجهة النظر هذه سيعزز التخيل، والإبداع، والمرونة الذهنية والتحكم في الذات.
مضاعفة الانتباه
وفقا لنظرية كابلان “لاستعادة الانتباه”، يجدد الدماغ على نحو أفضل موارده الإدراكيّة إن لم يستقبل إلا القليل من الإشارات الحسّيّة. وبتعريضه باستمرار لمختلف المنبهات المتعددة، ينتهي المطاف بقدرتنا على التركيز إلى الإنهاك، ولا نعود قادرين على توجيه أفكارنا. لنقل، تفرغ بطارياتنا العقليّة ولا يمكن شحنها إلا بالاتصال ببيئة ذات أصوات منخفضة، تحتوي على القليل من المنبهات. ووفقا لعلماء النفس، إنه في الطبيعة حيث يكون النجاح افضل: مشاهدة غروب الشمس، عدّ النجوم في السماء أو تنفّس الهواء المنعش في الغابة – كلّ هذه الأشياء من شأنها زيادة فعالية الدماغ.
مترجم (بتصرف) عن مقال آنا فون هوبفكارتن بالمجلة العلمية (Cerveau & Psycho) العدد 139- يناير 2022. ص.43-48.